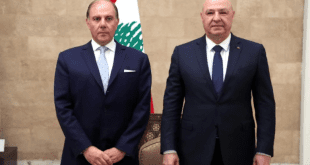في حمأة انشغال الوسط الداخلي بدعوة رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم، مقدماً الاستحقاق الرئاسي على استحقاق تشكيل الحكومة بعدما غرق الاخير مجدداً في مستنقع الشروط التعجيزية لرئيس الجمهورية، أعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل عن رفع سعر الصرف الرسمي الى ١٥ الف ليرة، منهياً بذلك ثلاثة عقود من تثبيت سعر الصرف على ١٥٠٧ ليرات.
يأتي قرار الخليل ليطرح مجموعة من التساؤلات حيال الخلفيات والحيثيات والتوقيت الذي قضى باللجوء الى قرار عجزت الحكومات المتعاقبة عن اتخاذه في ظروف اكثر ملاءمة وطبيعية من الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان اليوم تحت وطأة اكبر انهيار اقتصادي ومالي ونقدي شهدته البلاد منذ عقود.
لم يكن غريباً وصول السلطات الرسمية الى هكذا قرار بعدما انتفت الحاجة اليه اليوم، بعدما كان التثبيت احد عناصر شبكة الأمان التي حالت دون الانهيار الكامل للبنانيين. فالمصرف المركزي استمر في سياسة الدعم للسلع الاساسية وفق سعر التثبيت القائم على ١٥٠٧ ليرات، ما أتاح الحفاظ على سعر الأدوية والطحين والمحروقات لفترة من الوقت قبل ان يذهب الى قرار وقف الدعم الكلي عن هذه السلع. علماً ان هذه السياسة كانت سيفا بحدين، لأن شراء الوقت الذي عمد اليه الحاكم منذ بدء تعثر المصارف في أيلول ٢٠١٩، كبد الاحتياطي لديه بالعملات الأجنبية خسائر طائلة هُدرت خلالها تلك الاحتياطات بما يفوق العشرين مليار دولار، من دون ان تنجح في لجم الانهيار او كبح التضخم.
والمفارقة التي ربما تغيب عن المتابعين للشأن الاقتصادي تكمن في ان لا قانون او مرسوم او حتى تعميم يثبت سعر الصرف، بل كان الامر يقتصر على قرار حكومي صدر مطلع التسعينات بتأمين الاستقرار النقدي، ولم يتغير على مدى اكثر من ثلاثة عقود، رغم الكلفة الباهظة التي كبدتها سياسة ما عُرف بالاستقرار النقدي، بل كان يتم تجديده ضمن البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، بما يعكس سياسات تلك الحكومة حيال تثبيت الاستقرار النقدي عبر تثبيت سعر الصرف.
ورغم المطالبات المتكررة لصندوق النقد الدولي الحكومات اللبنانية بتحرير سعر الصرف، لم تجرؤ اي حكومة على اتخاذ هكذا قرار، فيما امتنع حاكم المصرف المركزي عن ذلك ايضاً بذريعة ان المصرف المركزي ينفذ سياسة الحكومة!
والواقع ان سلامة لم يتوقف عن دعم الليرة الا عندما طلبت منه حكومة حسان دياب ذلك قبل عامين، بالتزامن مع قرارها التخلف عن سداد سندات الدين، بحجة ان الاحتياطات يجب ان تُنفق على دعم المواد الاساسية للبنانيين وليس على دعم الليرة، علماً ان خطة حكومة دياب كانت تقضي برفع تدريجي لسعر الصرف بناء لطلب وزير المال غازي وزني والتزاماً بعدم القفز الى مستويات عالية، بل اعتماد رفع تدريجي ومرن وصولاً لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي.
إذن، رفع سعر الصرف الى ما يوازي سعر الدولار الجمركي، بما سيسمح للحكومة ان تحتسب ايراداتها ونفقاتها على أساس السعر الجديد، والهدف الوصول الى توحيد أسعار الصرف قدر الإمكان ووقف التعددية القائمة والناتجة عن التعاميم المتتالية للمصرف المركزي التي يحدد كل منها سعر مغاير عن الآخر، ما ساهم في خلق حالة من التفلت غير المسبوق في السوق، وعزز عمل السوق السوداء، التي، للمفارقة ايضاً، ستظل ناشطة، دافعة بالدولار الى مستويات خيالية جديدة، خصوصاً وان توقيت العمل بهذا القرار فتح الباب امام استغلال واستفادات ومكاسب ستتحقق.
الواقع ان قرار الخليل لم يكن مفاجئاً بل متوقعاً بعدما أقر البرلمان موازنة ٢٠٢٢، الحبلى بأفخاخ وتهريبات، لم تلفت نظر النواب المشرعين الذين تلهوا بقشور القانون وأرقامه من دون ان يُمعنوا في الهرطقات التي حفل بها، والتي ترمي وان في شكل غير مباشر الى دولرة الجباية في جزء كبير منها، بما ان بعض المواد تجيز للحكومة الاستيفاء بالدولار، كما تتيح لها او لوزير المال بتفويض منها، ولغايات فرض واستيفاء الضرائب والرسوم، ان تحددسعر تحويل للعملات الأجنبية. وقد اوردت الأسباب الموجبة لهذا القانون (المادة ١٣٣ مثلاً)، انه “بسبب التضخم الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد، ونظرا” الى تدهور قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية، وحيث انه من غير الجائز الاستمرار في استيفاء الضرائب والرسوم على الايرادات والأرباح التي تتحقق بعملة اجنبية، وعلى قسم المشتريات المستوردة المحددة بالعملة الأجنبية على أساس أسعار تحويلها الى الليرة وفق سعر ١٥٠٨، ونظرًا لحاجة الخزينة الى واردات لمواجهة العجز الذي تعاني منه (..)”.
كان قرار رفع الرواتب للقطاع العام والإعفاءات للمتقاعدين قد هدف الى استباق الإعلان عن خفايا الموازنة وضرائبها ورسومها الجديدة، من اجل امتصاص اي احتجاجات او نقمة ستخرج الى العلن في ما لو لم يُتخذ قرار الزيادة. فيما تِرك قرار تحديد الرسم الجمركي لوزير المال بمرسوم يصدر عن الوزارة، ليكون التطبيق العملي لسعر الصرف الرسمي الجديد.
اما الهدف الحقيقي وراء هذا الإجراء، والى جانبه القوانين الصادرة ضمن الموازنة التي تجيز استيفاء عدد من الرسوم بالدولار، فيرمي وفي شكل واضح الى اتخاذ الإجراءات الاستباقية والاحتياطية لتأمين ايرادات للخزينة بالدولار او بالليرة على سعر الصرف الجديد. وهذا يعني عملياً ان معدي الموازنة والسياسات العامة يستعدون لمرحلة طويلة من الفراغ الرئاسي والحكومي في ما لو صحت التوقعات بعدم نضوج اي من الاستحقاقين، والميل الى بقاء البلاد في حال من الفوضى والفراغ.
ولكن الواقع ان الأمر لن يقتصر على الفوضى والفراغ بل سيذهب ابعد نحو المحظور، بما ان رفع سعر الصرف لن يقتصر على ايجابيات منها تحسين الايرادات، ولا سيما على صعيد الضريبة على القيمة المُضافة والرسوم العقارية ورسوم الانتقال، والاقتراب من توحيد سعر الصرف، التزاماً مع مطالب صندوق النقد الدولي، وإنما ستكون له مفاعيله على مختلف انواع القروض ولا سيما السكنية منها، ( رغم ان بيان وزارة المال أشار اليها وإنما من دون تفصيل)، فيما لن يقف سداً في وجه استمرار تدهور العملة الوطنية، بما يؤذن بمستوى جديد من جحيم الغلاء والتضخم في ظل غياب اي شبكات حماية او أمن اجتماعي للفئات المهمشة والفقيرة!
السؤال الاهم اليوم، لا يقف عند حدود القرار بذاته، وباتت اسبابه وخلفياته مفهومة، وإنما عند توقيته. فالعمل به لن يبدأ قبل تشرين الثاني المقبل، اي بعد انتهاء الولاية الرئاسية. وهو بذلك يكشف البلاد على المخاطر المحدقة به اذا لم تتغير صورة الوضع نحو أفق أفضل، لجهة استحقاقي الرئاسة والحكومة وحتى الترسيم. وإلا، فإن البلاد مقبلة على مرحلة من الغموض القاتم دفعت بالمسؤولين الى تأمين احتياطاتهم المالية للسنة المقبلة.
اما الأسوأ فيذهب نحو القطاع المصرفي الذي يعلن عملياً ورسمياً اعتباراً من تشرين الثاني المقبل مفلساً! ذلك ان ميزانياته مقومة على دولار ١٥٠٧ ! ودولار ال١٥ الفاً سيعني ان رؤوس الأموال طارت وطارت معها رسمياً الودائع!!
النهار
 سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم