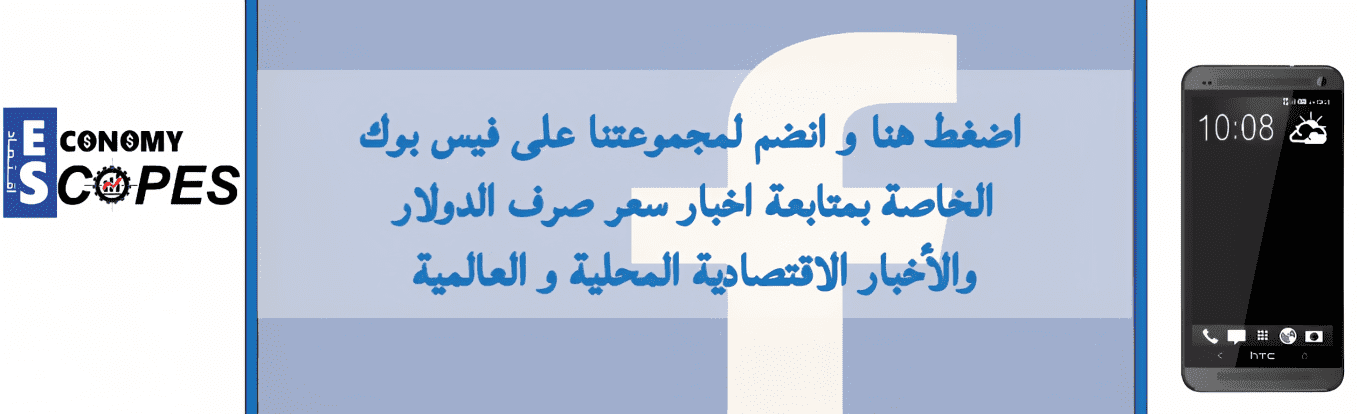ضربت الدولة كل مفاهيم علم الاقتصاد من خلال إقرارها ضريبة دخل مجحفة على موظّفي القطاع الخاص، بذريعة أنّهم يقبضون رواتبهم بالدولار، فيما رواتب موظّفي القطاع العام بالليرة. وهذا المنطق الذي لا ينمّ إلاّ عن جهل بالاقتصاد وتأكيد على فوضى سيطول أمدها بفعل الانعكاسات الاقتصادية السلبية لتلك الضريبة. في حين كان يمكن إقرار ضرائب على موارد أخرى تُدخِل لأصحاب الرساميل ملايين الدولارات، عبر استغلال أملاك الدولة.
الموظفون ضدّ بعضهم
وضعت الدولة موظّفي القطاعين العام والخاص مقابل بعضهم، لتبرير فرض الضريبة والحصول على موافقة شعبية ضمنية. فجلُّ القاعدة الشعبية لأحزاب السلطة، موظَّفة في القطاع العام أو تستفيد من خدماته، وتالياً، يسهل تجييشها لتأييد فرض ضريبة مرتفعة على أصحاب المداخيل بالدولار، حتّى وإن جرى تمييع الحد الفاصل بين مداخيل الموظّفين وأرباح التجّار وأصحاب المصالح الذين رفعوا أسعارهم واستوفوا من المستهلكين الضريبة على القيمة المضافة والرسم الجمركي على البضائع بسعر دولار السوق فيما دفعوا للدولة بالسعر الرسمي 1500 ليرة، منذ العام 2019 حتى اليوم.
كما تغاضى واضعو الضريبة أثناء إقرارهم موازنة العام 2022 عن حقّ الدولة في استيفاء مداخيل من استثمار أو الاعتداء على أملاكها البرية والبحرية والنهرية. ونسوا أن على الدولة تقديم الخدمات العامة مقابل دفع المواطنين للضرائب، وهذا ما لم يحصل. لكن العقل الجَمعيّ للجمهور، في ظل الأزمات، يبقى قاصراً عن ربط كل المعطيات ببعضها والتوجّه نحو سبب الأزمة، وإنما ينجرّ للحلول الأسهل والأسرع، والتي تشكّل في الحالة الراهنة، اقتطاعاً من دولارات القطاع الخاص لصالح تحسين أوضاع القطاع العام. لكن هل فعلاً سيصطلح حال موظّفي القطاع العام في ظل هذه الضريبة؟.
فرملة النشاط الاقتصادي
منذ العام 2019 لم تتّجه الدولة نحو تفعيل النشاط الاقتصادي. وهي منذ ما قبل الأزمة، اعتمدت أسلوب الاستدانة لتسيير الاقتصاد وتمويل القطاع العام المتخم بالموظفين والنفقات الصحية والتعليمية وغيرها. حتّى أنها لم تُجرِ تقييماً صحيحاً لتداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب ولم تلتزم بقرارها وقف التوظيف في القطاع العام. ولذلك، لا يمكن التذرّع بأوضاع موظفي القطاع العام لفرض ضرائب على موظفي القطاع الخاص، لأن ما آلت إليه أحوال القطاع العام، يتحمّل مسؤوليته من أدار السلطة منذ انتهاء الحرب الأهلية حتى اللحظة. رغم ذلك، من حقّ موظفي الدولة تحسين أوضاعهم. فالطرفان مظلومان.
إن تغاضي التطرّق للأملاك العامة منعاً لخدش أحاسيس شاغليها والمعتدين عليها، حَرَمَ الدولة من مداخيل كان يمكن استعمالها بدل فرض الضرائب على الرواتب والأجور. فعلى سبيل المثال، تقدَّر الأملاك النهرية التابعة للدولة بأكثر من 25 مليون متر مربّع، ولو فرض على شاغليها ومحتّليها 50 دولاراً سنوياً، فستحصل الدولة على ما لا يقل عن مليار و250 مليون دولار. فكيف إذا فرضت ضرائب على باقي الأملاك العامة؟.
اعتماد الصيغة الثأرية ضد الموظّفين لتغطية عجز الدولة، ستظهر تداعياتها أولاً في أسعار السلع والخدمات، إذ سترتفع. وكذلك أسعار الدولار في السوق السوداء. فيما النشاط الاقتصادي سيبقى جامداً. أما لو تم فرض ضرائب على الأملاك والموارد غير المستخدمة، ومنها العقارات والشقق الفخمة التي يملك كبار السياسيين والمصرفيين والتجار معظمها، فإنها ستحقق إيرادات للدولة، أو تُشَغَّل وتوظّف يداً عاملة، فتنشِّط الاقتصاد.
كل ما يمكن اعتماده، جرى التغاضي عنه. فالحل بالنسبة للمتضرّرين، سيكون التهرّب الضريبي، ولا تملك الدولة امكانيات الملاحقة الفعلية، إلاّ إذا أرادت اعتماد لجان التحقيق، وهذا مستبعد نظراً لعدم توافر الامكانيات والموارد. وبالتالي، فإن التقديرات تشير إلى أن ما يمكن تحصيله من ضريبة الدخل، لن يتجاوز 50 بالمئة من المبالغ المتوقّعة.
المصدر: المدن – خضر حسان