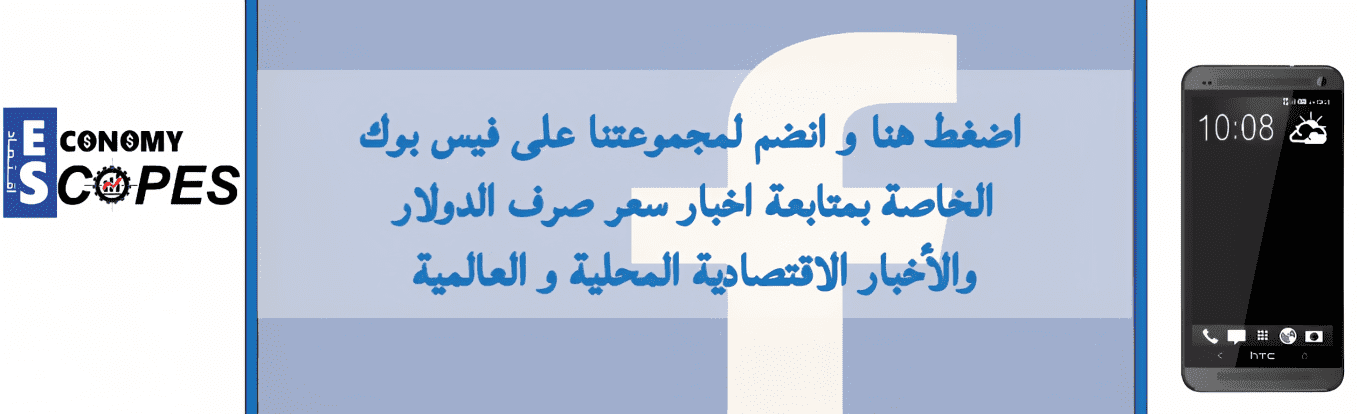/ غسان سعود /
حدى أبرز العثرات التي صادفت الرئيس نبيه بري في تعبيده طريق بعبدا أمام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هي مواقف صديقه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط؟ مواقف لم يكن يتوقعها أحد من زعيم المختارة بهذا الشكل الثابت واللجوج والفج على نحو يفتح الباب أمام النواب المعارضين لفرنجية والمترددين للقول إن على بري إقناع الأقربين قبل الأبعدين
الاشتراكيّ النائب السابق وليد جنبلاط، بنيته ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، لجس نبضه أو أخذ كلمة منه. ولم يكن أحد يتخيل أن يذهب جنبلاط في سلبيته إزاء ترشيح فرنجية إلى هذا الحد. لكن، ما هو معلوم وعلني، أن ديناميكية احتساب الأصوات بدأت فور إعلان الرئيس بري ترشيح فرنجية، قبل أن تعطلها بالكامل تتالي المواقف الاشتراكية المناوئة لترشيح فرنجية ليصبح الوصول إلى 65 صوتاً توصل رئيس المردة إلى بعبدا أمراً مستحيلاً. تأمين النصف زائداً واحداً كان سيفسح المجال لإطلاق معركة جدية من أجل تأمين نصاب الثلثين وتحميل القوى المسيحية مسؤولية عدم انتخاب رئيس، لكن تعثر تأمين النصاب الأول حال دون إطلاق معركة النصاب الثاني. وبدل أن يليّن جنبلاط مواقفه بمرور الوقت، كما كان بري ربما يعد نفسه، ازدادت مواقفه تصلباً، قبل أن ينتقل من وضع العصي في دواليب الـ65 إلى وضعها في دواليب الإليزيه حين أصبحت المعركة في الخارج. فها هو ينتقد، من باريس، السلة التي كان صديقه عرابها الأساسي. وهو أكثر من يعلم أن معركة فرنجية الرئاسية هي معركة سياسية وشخصية جداً بالنسبة لرئيس المجلس. في ظل مراعاة بري الدائمة لهواجس صديقه وتحالفهما الدائم، فإن أحداً لم يكن يتخيل أن يرد جنبلاط بهذا الشكل كل جمائل بري المتراكمة خلال السنوات الماضية. وإذا كان البعض لا يزال يراهن على “استدارة جنبلاطية” حين يجدّ الجدّ، فإن دعم بيك المختارة لبيك زغرتا يفقد وزنه المعنوي وقيمة أصواته إذا ما رسا الاتفاق الخارجي على فرنجية. وهذا الدعم مطلوب أمس قبل اليوم لتحقيق أربعة أهداف:
أولاً، تقريب القوى الداعمة لفرنجية من الـ 65 صوتاً لتحسين موقعها التفاوضيّ باعتبار أن مرشحها يملك أكثرية نيابية ولا ينقصه سوى النصاب، وهو ما حال جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل دون تحقيقه.
ثانياً، تثبيت فرنجية كمرشح وطني عابر للطوائف كما كان يبشر بري، قبل أن يسقط كل من جنبلاط ولقاء الاعتدال الوطني هذه الصفة، عبر حصر التأييد لفرنجية بالثنائي الشيعي وبقليل من النواب السنة والمسيحيين ممن يدورون في فلك الحزب والحركة. إذ كان يمكن لانضمام جنبلاط وكتلة الاعتدال (السنية بغالبيتها) أن يعزز “الإجماع الوطني” لتبقى “العقدة المسيحية” وحدها في منشار الاستحقاق، لولا أن جنبلاط حال دون ذلك، وأظهر أن تبنّي فرنجية يقتصر على طائفة واحدة.
ثالثاً، كان منتظراً من جنبلاط تشغيل محركاته الخارجية لتوسيع هامش الدعم للمرشح المدعوم من حليفه المفترض، فيما هو تحرك عكسياً نحو باريس لوضع العصي في دواليب التسوية المنتظرة، محاولاً شدها إلى الخلف بدل دفعها إلى الأمام.
رابعاً، رغم إثبات التجارب أن كل ما يشاع عن “أنتينات” المختارة مجرد وهم بعدما ثبت أن جنبلاط لا “يصيب” أبداً (وأحداث سوريا خير شاهد)، إلا أن تموضع البيك له تأثيره في المزاج السياسي والإعلامي العام، وهو كان يمكن أن يعطي لترشيح فرنجية زخماً معنوياً كبيراً، فيما رفضه لهذا الترشيح يعمم حالة التشكيك ويدفع نواباً من خارج الكتلة الجنبلاطية إلى ضبط حماستهم و”عدم التهور”.
اللافت أن زعيم المختارة حاول، بداية، ربط موقفه من ترشيح فرنجية بموقف التيار والقوات وعدم رغبته باستفزاز المكون المسيحيّ، وكأنه طوال مسيرته السياسية كان متطوعاً في جمعية مار منصور، قبل أن يربط موقفه من هذا الترشيح بعد عودته من باريس بموقف ابنه النائب تيمور جنبلاط الذي يريد “تجديد” الطبقة السياسية، رغم أنه يحتل اليوم المقعد الذي كان يشغله جده! وهذه نكتة جنبلاطية لم يبتسم لها النائب وائل أبو فاعور نفسه، فآثر “أبو تيمور” الانكفاء وعدم تقديم أية مبررات لغدره بصديقه القديم. والمؤكد، وفق مطلعين، أن لا علاقة لموقف جنبلاط من قريب أو بعيد برؤية تيمور “الإصلاحية” وإصراره على العمل السياسي “على طريقته” ومشاكله الشخصية، وإنما باستشعار جنبلاط الأب حجم التغييرات التي تندفع المنطقة نحوها، عشية التسلم والتسليم المتعثر في المختارة.
ويقول أحد اللصيقين بعقل جنبلاط إن حلفه مع سعد رفيق الحريري كان يشبه إلى حد كبير حلفه مع الرئيس نبيه بري، لكنه كان من أول من قفز من المركب الحريريّ الغارق حين تخلت السعودية عنه. وهو يتخذ مواقفه من منطلق الاستعداد السعودي لمصالحة الحوثيين فيما ترفض الرياض في الوقت نفسه مصالحة الحريري، تماماً كاستعداد دمشق لمصالحة حماس وفصائل فلسطينية أخرى شاركت مباشرة في الحرب على الدولة السورية فيما ترفض مصالحة بري. وهو إذ يقدر الصداقات الداخلية، فإنه يعتبرها مصدر قوة له إذا كانت ترتبط بصداقات إقليمية، ومصدر ضعف إذا كانت ستترتب عليها عداوات إقليمية. ولا يحتمل في لحظة تحولات إقليمية أن يكون شخصية مستفزة لكل من دمشق والرياض. وإذا كان قادراً على تحمّل فيتو الأولى عليه في ظل الانكفاء السوريّ لبنانياً، إلا أنه لن يخاطر يتحمل فيتو الثانية في ظل الانخراط السعودي لبنانياً. لذلك، بين صديقه اللبناني وصديقه الإقليمي، يختار الثاني خصوصاً إذا كان الأول متفهماً كما هو بري الذي يؤكد بدوره أن السعودية ممر إلزامي لانتخاب الرئيس. ويذكّر أحد المقربين من جنبلاط أن الأخير اختار المملكة حين خُيّر بينها وبين صديقه سعد الحريري، تماماً كما يختار المملكة حين يخير بينها وبين صديقه نبيه بري، ولن يقدم على أي خطوة جدية في الاستحقاق الرئاسي من دون إيعاز واضح ومباشر وشفاف من المملكة. وهو إذ يحافظ على استقرار العلاقة مع الرياض منذ عام 2014، ويلتزم بما تقرره في الانتخابات النيابية ومشاركته الحكومية وغيرها، فإنه لا يقارب الأمر من منطلقات مالية أو أمنية أو سياسية كما يفعل كثيرون، بل من منطلق الهاجس الدائم لدى الأقليات السياسية والطائفية بوجوب أن يكون لها “ظهر إقليمي” يحميها من التحولات المحيطة. وهو – خلافاً للزعماء الموارنة -لا يرى حرجاً في القول إنه ليس قوة عظمى لا يمكن القفز فوقها إنما لاعب محلي ثانويّ جداً في المشهد الإقليميّ ينتظر اتفاق اللاعبين الأساسيين للاقتراع لمن يريدونه.
في الشكل، يمكن القول إن جنبلاط عطل احتمال جمع 65 صوتاً لفرنجية، وأخرج الأزمة من إطارها المسيحيّ – الشيعيّ عبر توسيع رقعة الاعتراض على فرنجية في ظل انكفاء التغييريين المفترضين وتحييد لقاء الاعتدال لنفسه، وعزز نظرية احترام المكوّن المسيحي في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، ولو أن أحداً لا يصدقه في ذلك. أما في المضمون، فيكشف جنبلاط حقيقة الموقف السعوديّ. في ظل استراتيجية “الكفوف البيضاء” التي تلتزم بها الديبلوماسية والصحافة السعوديتان، يكاد يكون جنبلاط المؤشر الأساسي لما تريده المملكة، وهو أكثر مصداقية في هذا السياق من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يمكن أن “يشطح أحياناً ويصدق أنه يمكن أن يقود المملكة. أما جنبلاط فيعرف حجمه ودوره، ويقول الأمور كما هي من دون إضافات. ما يقوله جنبلاط في الإعلام هو ما تقوله المملكة اليوم في الغرف المقفلة، ومن تريد إحراقهم في السر يحرقهم هو في العلن، ومن ترشحهم سراً يجهر بترشيحهم. وفقط حين “تُكوّع” هي – إذا فعلت – “يُكوع” هو. هكذا كان، وسيبقى.