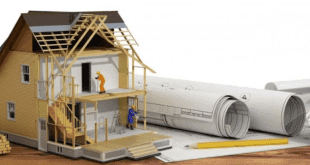كتبت سلوى بعلبكي في النهار”:
علّة الاقتصادات الضعيفة انها اقتصادات تنمو في احضان المساعدات الخارجية، أو على استثمارات ريعية يختفي كلاهما او يتوقف عند اي اهتزاز امني كبير أو عند اي تمايز في التموضع السياسي، فيدفع المواطنون ساعتئذ الثمن الأكبر عندما تتوقف عجلة النمو وتبدأ العملة الوطنية بالتقهقر وخسارة قيمتها الشرائية.
ليست المرة الاولى التي تنهار فيها الليرة اللبنانية، وليس جديدا على اللبنانيين ان تتحول أسواقهم الى “التدولر” وتغدو البضائع فيها اشبه بمقتنيات ثمينة تعجز الغالبية الساحقة من المواطنين عن شرائها. فلبنان الذي ابتُلي على مدى عقود بسلطات لم تعِ أو تدرك أن بناء أي اقتصاد ثابت ومستقر وناجح قادر على حماية الاستقرار الاجتماعي، يعيش اليوم نتائج هذا الجهل في ادارة شؤون الدولة والاقتصاد، إذ لا يملك الاقتصاد اللبناني عمليا قطاعا زراعيا قادرا على المنافسة والتصدير وخلق فرص عمل واستثمارات واكتفاء ذاتي للبنان، كما انه لا يملك قطاعا صناعيا يمكن لمنتجاته أن تخترق الحدود بجودتها واسعارها التنافسية وتعود الى لبنان بالعملة الصعبة لتعيد تعزيز الاستثمار والنمو.
وإذا كانت هذه العوامل من الاسباب الرئيسية لاجتياح الدولرة الاسواق والقطاعات، بَيد ان ثمة عوامل أخرى تساهم في دولرة الاسعار التي تُعتبر نتيجة طبيعية لعدم واقعية تعدد أسعار الصرف التي يعتمدها المصرف المركزي، برأي الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري، لافتا الى أن “ثمة قيماً حقيقية للسلع والخدمات التي يجري تبادلها بين العارضين والمشترين، وهذه القيم يجب أن تغطي التكاليف مضافا إليها الأرباح التي تتضمن علاوة المخاطرة للمنتج او التاجر”.
ويشرح أن “السعر النهائي هو تعبير عن عنصرَي الكلفة والربح، وما لم يكن كذلك، اي في حال فرضت الدولة سعرا لسلعة او خدمة ما لا توازي القيمة الحقيقية، وجب عليها أن تغطي الفارق من الموازنة العامة وهو ما يُعرف بالدعم. وما يحصل اليوم هو أن الدولة تتحلل من كل أشكال الدعم سلعة بعد سلعة وخدمة بعد خدمة، وذلك يوجب على العارضين من منتجين وتجار ووسطاء أن يعيدوا تسعير البضائع والخدمات بما يعكس القيمة الحقيقية الخالية من الدعم”.
ويميز الخوري بين نوعين من السلع والخدمات، “النوع الأول الضروريات التي يجب أن تتدخل السياسات العامة لعدم حرمان المواطن منها كالخبز والتعليم والدواء والاستشفاء والنقل والتدفئة، والتي يجب ألّا يكون المواطن عرضة معها لمعادلة العرض والطلب الفعال، والثاني ان تقوم الحكومة بتأمين شبكة امان اجتماعي متكاملة تحمي الفئات الأضعف من خلالها (وهي بالمناسبة غير البطاقة التمويلية الموقتة والتي تنضح برائحة الرشوة الانتخابية). أما ما خلا ذلك فيجب تركه للتفاوض في السوق الحرة”. ويخلص: “لا يمكن دفع المورّدين والشركات للبيع من دون أرباح، فهذا يخالف طبيعة عمل السوق”.
ينحصر دور الدولة هنا نظريا بمحاربة الاحتكار والربح الفاحش وليس تحديد الاسعار. ويعطي الخوري مثالا عن قطاع الصيدليات الذي “أدى فارق السعر فيه الى تدمير وتبديد جنى عمر معظم الصيادلة، وهم في الغالب من الطبقة الوسطى، عبر إجبارهم على بيع مخزوناتهم عند السعر الرسمي، بما أدى إلى انخفاض قيمة المخزون بالتدريج حتى بلغ 4% من قيمته التي دفعها الصيدلي لشراء مخزونه بالأصل. اما المستشفيات فمشكلتها أكبر بكثير لأنها دائن أساسي لوزارة الصحة والمؤسسات العامة الضامنة، بدليل أن حجم دَين المستشفيات على الدولة بلغ 204 مليارات ليرة مع بداية الأزمة. وتاليا فإن السؤال عن القيمة الحقيقية لهذا الدين اليوم الذي لا يتجاوز الـ 150 مليون دولار بسعر السوق الحرة”!
إذاً، الدولرة وفق ما يقول الخوري “هي مسار طبيعي حين يتم نزع الدعم لأن التكاليف والثروات لا تكذب. فالكذبة الكبيرة هي تعدد أسعار الصرف المفروضة عنوة على الثروات والوحدات الاقتصادية، وكما يقوم المثل الدارج “يللي بدو يعمل جمّال بدو يعلّي باب داره”. الدولة تريد أن تمارس دور الجمّال لكن أبوابها باتت تلامس الأرض. تلك هي الحقيقة المُرة”.
قطاع المولّدات
يُعدّ قطاع مولدات الكهرباء في الأحياء والقرى قطاعاً غير منظم وهو جزء من الأسواق المعروفة بالسوداء، رغم المحاولة التي قامت بها وزارة الإقتصاد لتسعير الكيلواط من المولدات، وهو ما اعتُبر من ناحية، إعتراف غير مباشر بهذا القطاع وبداية حوكمته، علما أنّ معظم أصحاب المولدات غير مسجلين كمؤسسات تجارية ولا يدفعون الضرائب وليس لديهم تأمين لعمالهم أو ضمان إجتماعي أو طوارئ عمل من أي نوع كان. لكن الإعتراف بأن هذا القطاع موجود هو بسبب غياب القدرة على تأمين الكهرباء بدون تقنين من مؤسسة كهرباء لبنان أو من الإمتيازات، علماً أن الإمتيازات تشغّل أيضاً مولدات خاصة بها”.
بعد الأزمة وتعدد أسعار الصرف، ورغم الأرباح الفاحشة التي حققها أصحاب المولدات منذ الحرب الأهلية، تحوّل هذا القطاع إلى قطاع يعيش على تناقض جوهري بين ارتفاع عناصر الكلفة من ناحية ولا واقعية التسعيرة الرسمية للعدّاد وضعف ميزانية القطاع المنزلي لمواكبة أسعار الطاقة من ناحية ثانية. امام هذا الواقع يميز الخوري بين مسألتين: “الاولى تعرّض أصحاب المولدات لمخاطر سعر الصرف، بمعنى أنهم يقبضون بالليرة ويدفعون ثمن المازوت والصيانة بالدولار الأميركي، وفي حالات كثيرة يلعب عامل الفارق الزمني بين التحصيل بالليرة وشراء الدولارات اللازمة لتسديد ثمن المازوت في غير مصلحة هؤلاء، في ظل الإرتفاعات الجنونية اليومية لسعر صرف الدولار في السوق الموازية. وتاليا لتجنب هذه المخاطر يلجأ هؤلاء الى طلب التسديد بالدولار من المواطنين الذين قد يستغنون عن الكثير من النفقات الأخرى، وقد يلجأون إلى تشذيب إستهلاكهم من ضروريات أخرى من أجل دفع قيمة إشتراك المولد ولو بالدولار”.
اما المسألة الثانية “فتتعلق بمدى عدالة السعر الذي يفرضه أصحاب المولدات بالدولار، وهذا لا يمكن أن يُترك للتفاوض الحر بين هؤلاء وبين المواطنين”. لذا يدعو الخوري وزارة الإقتصاد الى أن تتدخل لتحديد نسبة أرباح هؤلاء عند التسعير بعملة ثابتة، تماما كما كانت تفعل لسعر الكيلواط للمولّد بالليرة اللبنانية.
الدولرة مخالِفة للقانون؟
ليس مستغربا بل طبيعي جدا أن تكون معظم السلع مسعّرة بالدولار الأميركي، على اعتبار أن معظم السلع مستوردة وتاليا وجب تسديد ثمنها بالدولار. فهل يجيز القانون ذلك؟ يلاحظ المحامي المتخصص في القوانين المصرفية والإقتصادية الدولية الدكتور علي زبيب أن “ظاهرة التسعير بالدولار أصبحت معمّمة ومشرّعة من دون ان تتحرك وزارة الاقتصاد أو النيابة العامة للجمها، علما أن اعتماد الدولرة والتسعير بالدولار مخالف للقانون، كما ان الامتناع عن قبض الليرة اللبنانية هو أمر مخالف لقانون النقد والتسليف ويعاقب عليه قانون العقوبات بالسجن والغرامة”. لكن الاخطر برأي زبيب “ما يتعلق بفوضى تسعير الدولار التي أصبحت متحكمة بالسوق، إذ ثمة غوغائية وعدم انتظام بشكل غير مسبوق على نحو ادى الى خلق حالة مضاربة بالاقتصاد أدت الى تدميره”.
والدليل الذي يستند اليه زبيب هو “سعر الصرف الرسمي الذي لا يزال على سعر 1500 وخسر 2000% من قيمته الحقيقية. في المقابل ثمة حالة فلتان كبيرة في قطاعات كثيرة كالمستشفيات وشركات التأمين وأخيرا المولدات الكهربائية الذين تتغاضى الدولة عن معاقبتهم أو ملاحقتهم بحجة أنهم يسددون كل مشترياتهم بالدولار … ولكن هذا كله، وفق ما يقول زبيب “يدخل ضمن الاقتصاد الموازي والاقتصاد الاسود”.
ولا ينسى زبيب الاشارة ايضا الى أن “المشكلة الحقيقية تكمن في الإقتصاد النقدي حيث لم يعد هناك اي رقابة على الأموال والدولارات التي تدخل الى المصارف، بما يؤدي الى تضليل ميزان المدفوعات على اعتبار أن قيمة الاموال التي تدخل أو تخرج من البلاد غير معروفة”. ويشير الى أمر أخطر يتعلق بالاقتصاد النقدي كونه يحفز على عمليات تبييض الأموال، و”هذا يحدث كثيرا في هذه الفترة، حيث لم تعد المصارف تدقق في مصدر الدولارات “الفريش” على عكس ما كان يحصل سابقا عندما كانت المصارف تسأل وتدقق كثيرا في مصدر الاموال”. الى ذلك، يرى زبيب أن “عملية الدولرة حفزت تجارة الشيكات المصرفية وزادت المضاربة على العملة اللبنانية لأن الناس تضطر الى شراء الدولار من السوق السوداء لتسديد مشترياتها بالدولار، بما أدى الى زيادة الطلب وانخفاض العرض”.
كل هذه الامور ادت برأي زبيب الى “كسر في الانتظام المالي العام ومفاقمة الازمة الاقتصادية وضرب الليرة اللبنانية أكثر وأكثر بما يدفع البنك المركزي الى طبع مزيد من العملة بغية زيادة الرواتب وتسديد رواتب القطاع العام، وهذا كله سيؤدي الى مزيد من التضخم المفرط الذي هو مدمر فعليا للإقتصاد”.
 سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم